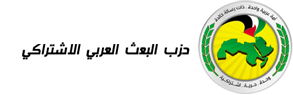حين كان سكّان إمبراطورية الأزتيك يموتون بأعداد كبيرة كل يوم من أمراض وفيروسات جلبها الأوروبيون معهم، لم يَمُت أي من المستعمرين الإسبان. كانوا يمتلكون مناعة وفَّرتها لهم تجربة طويلة مع الأوبئة التي ضربت القارة الأوروبية، وما سُمي بـ"العالم القديم".
لهذا، قَبِلَ سكّان المكسيك حينها ادعاءات الإسبان بأنّ إلههم القويّ يحميهم، فيما آلهة السكّان الأصليين التي عبدوها لمئات السنين، وأديانهم التي آمنوا بها ومارسوا تعاليمها لقرون، تعجز عن ذلك. هكذا أُبيدت أديان وثقافات وأنماط حياة عمرها آلاف السنين، وانتهت إلى الأبد، وبدأ أتباعها بالتحول إلى المسيحية بسبب التفسير الغيبي للوباء حينها، إلى درجة أن أميركا اللاتينية تشكّل هذه الأيام نصف العالم الكاثوليكي تقريباً.
هذا جانب من دور الأوبئة في التاريخ، أي تبعاتها الثقافية التي يندر أن نسمع عنها، لأنها لا تتفق مع السردية الغربية عن صعود هذا العالم وهيمنته ثقافياً أيضاً. في الحقيقة، يربط بعض المؤرخين والباحثين في تاريخ الأوبئة بين تحوّل الإمبراطورية الرومانية إلى المسيحية، وحتى دخول البوذية إلى الصين، وانتشار الأوبئة التي اجتاحت هذه الإمبراطوريات[i]، فهذه الأديان وفَّرت حينها رؤية جديدة ومختلفة عن الموت ومعناه، وبالتالي كانت قدرتها على المواساة في حالة الانتشار الواسع للموت أكبر من الأديان التقليدية التي سبقتها.
تبعات الأوبئة يمكن فهمها بعمق، إذاً، بالتركيز على دورها في التحولات العميقة والبعيدة المدى، لا على عدد الإصابات والضحايا اليومي فحسب، كما سنرى.
الأوبئة والتأريخ
قبل أقل من قرن بقليل (العام 1935)، نشر عالم البكتيريا الأميركي هانز زينسر كتابه الأشهر "الفئران، القمل، والتاريخ"، بتصدير لافت يعكس إدراكاً لخروجه قليلاً على التّقليد السائد في التأريخ حينها، والمتمثّل في استثناء شبه كلّي لأيّ دور للأمراض والأوبئة في تشكيل الأحداث التاريخيّة، حتّى لا نقول تغيير مسارها أو تحديده كلياً.
لكن، ورغم اكتفاء زينسر بالعمل فقط على تبيان دور تفشّي وباء التيفوئيد في "إرباك أفضل خطط الملوك وقادة الجيوش" في التاريخ، كما قال، فيمكن اعتبار كتابه هذا مقدّمة لنمط تفسيريّ جديد للتاريخ سيتطوَّر لاحقاً، وسيعيد تشكيل فهمنا للتاريخ في السنوات اللاحقة، باستدخاله متغيّرات غير اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية في صناعة التاريخ، ففيه يزعم ينسر "أنّ التيفوئيد، مع إخوته وأخواته الآخرين (كالطاعون والكوليرا والتيفوس والزحار أو الديزنتاريا)، حَسَمَ مصير حملات عسكريّة أكثر بكثير من يوليوس قيصر وهانيبال ونابليون، وأكثر بكثير من كلِّ الجنرالات الآخرين المرموقين في التاريخ".
وفيما يتم إلقاء اللوم على الوباء لتبرير الهزيمة أحياناً، "يحصل الجنرالات دائماً على السّمعة والفضل في النصر، رغم أنَّ من المفترض أن يكون الأمر عكس ذلك تماماً". وبسبب هذا الإدراك، ولو المحدود، لدور الأوبئة (أي دور الأوبئة في تحديد مصير الحملات العسكرية وحسمها)، يفترض زينسر أنه "ربما سيأتي اليوم الذي يتغير فيه تنظيم الجيوش، بحيث يقوم الضابط (العسكري) بتنفيذ أوامر الطبيب العام في الجيش ويخضع له، لا العكس".
لكنَّ دور الأوبئة في الحقيقة، وكما سنرى، أكبر وأكثر تعقيداً من مجرد حسم معركة عسكرية، أو حتى تغيير مسارات حروب كبرى، أو تبعات ذلك على المسار الَّذي قد يأخذه التاريخ نتيجة لهذا الدور. يذكر ويليام ماكنيل في كتابه الفذ "أوبئة وبشر" أنَّ الحرب البلوبونيزية الشهيرة بين أثينا وأسبرطة في الثلث الأوّل من القرن الرابع قبل الميلاد، ربما تكون قد حُسِمَت فعلاً بسبب وباء أصاب الجيش الأثيني، كما ذكر ثوسيديس، المؤرخ الأهمّ لهذه المواجهة التاريخيّة الكبرى. لهذا، يتساءل ماكنيل: "كيف (وكم) كان التاريخ السياسي (والاجتماعي) اللاحق لـ (منطقة) البحر المتوسّط سيختلف لو انتصرت أثينا في تلك الحرب؟".
القضية الأساسية في هذه القراءة ليست أن حسم المعارك والحروب مرتبط حصراً وأساساً بإصابة الجيوش بالفيروسات، أو حتى بانتشار الأوبئة في صفوف الجنود والمقاتلين، بل بفهم دور الأوبئة والفيروسات في التحولات العميقة والبعيدة المدى التي تصيب بنية المنظومات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. وما الإرهاق والتعفن الذي يصيب مجتمعات هذه الجيوش وينهكها نتيجة الأوبئة، إلا أحد تجلياتها فقط، رغم أن مفاعيل هذا الإنهاك وتبعاته تكون أيضاً عادة عميقة وطويلة المدى، وقد تمتد إلى عشرات أو مئات السنين، فضعف المجتمعات وترهّلها واستنزافها من قبل الأوبئة (اقتصادياً، ديمغرافياً، سياسياً، اجتماعياً، تعليمياً، إيديولوجياً...) سينعكس حتماً على الجيوش وعلى أدائها، حتى لو كانت سليمة ومعافاة من الأمراض. هكذا، مثلاً، يرى بعض المؤرخين أحد أسباب سقوط الإمبراطورية الرومانية الأساسية (دخلت الأوبئة مجال دراسة وتفسير سقوط الإمبراطورية الرومانية مؤخراً فقط، مثل كتاب كايل هاربر الذي صدر قبل عامين "مصير روما: المناخ، المرض، ونهاية إمبراطورية")، فيما يجادل مؤرخون آخرون أنَّ التبعات العميقة والبعيدة المدى للأوبئة كانت أحد أسباب نجاح المسلمين في هزيمة كلٍّ من الفرس والروم.
ففي "أوبئة وبشر"، يجادل وليام ماكنيل أنه "كما في حالة الأوبئة العظيمة السابقة (165-180م) ومن (251-266م)، كانت الآثار السياسية لهذا الطاعون بعيدة المدى. في الواقع، إنَّ فشل جهود جستنيان الأول (الإمبراطور البيزنطي 525-548م) لاستعادة وحدة الإمبراطورية في البحر الأبيض المتوسط، يمكن أن يُعزى إلى حد كبير إلى تناقص الموارد الإمبراطورية الناتجة من انتشار الطاعون. وكذلك، يمكن اعتبار أنّ فشل القوات الرومانية والفارسية في تقديم أكثر من مجرد مقاومة رمزية للجيوش الإسلامية التي اجتاحت الجزيرة العربية فجأة في العام 634، يصبح أسهل للفهم في ضوء الكوارث الديموغرافية التي أصابت، وبشكل متكرر، سواحل البحر المتوسط من العام 542م فصاعداً، ورافق المسلمين في المراحل الأولى من توسعهم الإمبراطوري".
كيف يجب أن لا نفكّر في دور الأوبئة في التاريخ؟
لكن كتاب زينسر، ومثله القليل، حتى وقت قريب، ممن التفت جزئياً إلى دور الأوبئة وتأثيرها في الأحداث، لم يتضمن اعتماد نمط تفسيري جديد كلياً للتاريخ، بل ظلت الأوبئة في تلك السرديات تبدو مجرد انفجارات مفاجئة غير متوقّعة، وحتى خارجة على القاعدة والمنهجية التقليديّة التي استمرت في إلهام المؤرخين عموماً، وحتى بدت دائماً استثناءً لها.
وفي الوقت نفسه، ظلّت مقدّمات بعض أسس هذا النّمط التفسيريّ، رغم محدوديّته الكبيرة حتى ذلك الوقت، موضع اهتمام عدد قليل جداً فقط من المؤرخين المحترفين والمتخصّصين الذين غيَّروا لاحقاً طريقة تفكيرنا في التاريخ عبر استدخال دور الأوبئة وتفسير صعود الإمبراطوريات وأفولها.
هذه قضيّة، إذاً، مرتبطة بفهم التاريخ ورؤيته، وحتى كتابته. أحد أسباب القصور الَّذي أسّس لهذا الخلل المعرفي الذي تجاهل دور مُتغيّرات وعوامل قد تكون حاسمة أحياناً في صناعة التاريخ لصالح المتغيرات التقليدية السائدة، في رأيي، هو هيمنة المركزية المعرفية الأوروبية، والرؤية الحداثية للتاريخ والمجتمع، فهذه الرؤية تفترض أن مسار التاريخ يختزن معنى وغاية (هكذا ينتهي كل استنتاج في أي مجال عادة بفوقية أوروبا والغرب ودونية مجتمعات الجنوب، لكون المركزية المعرفية الأوروبية إحدى أدوات الهيمنة)، وتفترض كذلك حتمية انتصار الإنسان الحديث وخضوع الطبيعة.
في الحقيقة، حتى الإمبراطورية الرومانية اعتقدت في أوج صعودها أنها لم تُطوِّع البشر وتُخضعهم فقط، بل والطبيعة أيضاً، كما يشهد على ذلك طقوس استعراضهم لأكثر الحيوانات المفترسة ضراوة، كالأسود والنمور، في احتفالات الإمبراطورية الكبرى، والتي كانت تنتهي بقتلها على مرأى من الحضور في المنتدى الروماني، لكن نهاية الإمبراطورية كانت، من ضمن أسباب عديدة، نتيجة تحولات عميقة بعيدة المدى استمرت لعقود، أدت فيها أصغر الفيروسات بما لا يقاس بالأسود أو الفيلة دوراً مهماً، كما يشير كايل هاربر في "مصير روما".
الأهم من ذلك، أنَّ المنظور والمنهج المعرفي الأوروبي المركزي، والمنظور الحديث عموماً، وبسبب بنيته وطبيعته والفلسفة التي يستند إليها، يعمد عادة إلى أن "تكون التجربة الإنسانية منطقية" أو مفهومة، كما يقول ويليام ماكنيل في "أمراض وبشر".
ولهذا، "يلبي المؤرخون عادة هذا المطلب، من خلال التأكيد على عناصر في الماضي يمكن حسابها، تعريفها، قياسها، وتحديدها بدقة، ويمكن أيضاً حتى التحكّم بها في كثير من الأحيان". ولهذا السَّبب بالضبط، عندما كان دور الأمراض والأوبئة حاسماً في قضايا الحرب والسلم، وعندما أصبح (بالتالي وبالضرورة) يتعارض مع الجهود المبذولة من قبل المؤرخين ومنهجيتهم التقليدية لجعل الماضي مفهوماً (وقابلاً للحساب والتحديد الدقيق والتعريف والقياس، كما هي المنهجية الحديثة)، تم التقليل من أهمية دور الوباء، وتم استثناؤه أيضاً.
كيف يجب أن نفكّر في دور الأوبئة في التاريخ؟
ماكنيل، في "أمراض وبشر"، يتجاوز كثيراً ما بدأه زينسر في "الفئران، القمل، والتاريخ"، وهو ينتمي إلى فئة صغيرة جداً من المؤرخين المحترفين الجادين الَّذين رأوا مهمتهم في شرح الماضي، وفي التفسير التاريخي، عبر استدخال تاريخ الأمراض المعدية وتاريخ الأوبئة، من خلال إظهار كيفية تأثير الأنماط المختلفة لتداول الأمراض (وأحياناً بشكل حاسم جداً) في الشؤون البشرية في العصور القديمة والحديثة، وحتى في مسار التاريخ ذاته.
ربما يكون الأهم بينهم حتى الآن، غير ماكنيل طبعاً، كتاب ألفريد كروسبي "الإمبريالية الإيكولوجية: التوسع البيولوجي لأوروبا 900-1900"، فقد أعاد كروسبي، وبشكل ملموس، وعبر استخدام البيانات المتوفرة إلى حد كبير (وليس فقط عبر النظرية والمنهج الجديد) إعادة رواية حقبة مهمة من التاريخ الإنساني، عبر تقديم رواية مؤسسة على العوامل الإيكولوجية والبيولوجية للتاريخ الإنساني منذ القرن العاشر، وحتى إعادة قراءة أهم التجارب الاستعمارية الأوروبية وأسباب نجاح أو فشل بعضها ارتباطاً بأسباب بيئية وبيولوجية (من مناخ وتربة ورياح إلى أوبئة وبيولوجيا ومناعة).
هكذا، إذاً، لم يعد تاريخ الأمراض أو دور الأوبئة في التاريخ، للمرة الأولى ربما، مجرد اختصاص محدد ومحدود جداً (كبعض مدارس علم الآثار المتخصصة جداً)، تقوم في سياقه مجموعة من المؤرخين والباحثين المتخصصين فقط بتسجيل بيانات عن الأوبئة وانتشارها وعدد ضحاياها، لمجرد أنَّها متوفرة في الأرشيفات، أو لمجرد أنها حدثت فعلاً، بينما لا يسجلون لها أي تبعات تاريخية كبرى، أو حتى محدودة أحياناً. ولهذا تبقى، وتبدو، بلا معنى على الإطلاق في سياق الصورة الكبرى للتاريخ.
ومن أجل فهم أكثر شمولية لدور الأوبئة في التاريخ، طبعاً، هناك ضرورة لدمج كل تجارب الشعوب، عبر فحص دقيق ومعمق للنصوص الأركيولوجية القديمة المتوفرة من قبل خبراء في كل اللغات، ومن كل المجتمعات، فكل ما دخل التاريخ، للأسف، في هذا المجال حتى الآن يبدو مقتصراً على التجربة الأوروبية، وعلى ما كتب باللغات الأوروبية عموماً، فمنذ اقتحام فيروس كورونا حصون القوى العظمى، بدأت وسائل الإعلام الغربية وغير الغربية تستعيد سرديات من تاريخ الأوبئة وترويها، لكنّها كانت بالإجمال سرديات أوروبية حول الأوبئة التي ضربت أوروبا والأوروبيين، أو، بالحد الأدنى، تأثرت بها أوروبا والأوربيون (أثناء حقبة الاستعمار مثلاً).
ربما سمع أو قرأ أو عرف الجميع، مثلاً، هذه الأيام عن "الموت الأسود" أو الإنفلونزا الإسبانية" وغيرها، لكن هذه المركزية الأوروبية المعرفية لا تستثني فقط ما حَلَّ بغير الأوروبيين (إلا بشكل هامشي، وحين يكون مرتبطاً بأوروبا فقط)، بل وتستثني الأدوار الأهم التي أدتها الأوبئة على الإطلاق في تغيير مسار التاريخ البشري بشكل كبير أحياناً، فلا يمكننا، مثلاً، تفسير كيف استطاع أقل من 600 بحار ومغامر إسباني، بقيادة هيرنان كورتيز، في أوائل القرن السادس عشر، القضاء على إمبراطورية الأزتيك العريقة في المكسيك بالقوة العسكرية فقط. في الحقيقة، هذا الأمر يبدو مستحيلاً، وخصوصا إذا عرفنا أن الأمراض التي جلبها الإسبان معهم قضت على أكثر من ثلث سكان تلك الإمبراطورية.
الأمر نفسه ينطبق على حملة فرانسيسكو بيزارو على إمبراطورية الإنكا التي كانت في أوائل القرن السادس عشر الإمبراطورية الأكبر مساحة جغرافية في زمنها على الإطلاق. أما ما حلَّ بالسكان الأصليين في أميركا الشمالية، فربما يكون المثال الأهم على حدث تاريخي مفصلي جداً كان للبيولوجيا والأوبئة دور حاسم فيه، وغَيَّرَ وجه التاريخ، رغم أننا لم نسمع عنه مطلقاً مع حلول جائحة كورونا. فبحسب إحصاء العام 1890، لم يبقَ من السكان الأصليين سوى ربع مليون فقط (250 ألفاً) من أصل 18 مليوناً ونصف المليون كانوا يقطنون أميركا مع بداية الاستعمار الأوروبي.
وليعرف المرء حجم الكارثة، يمكنه فقط قراءة المقارنة التالية التي أدين بها لصديقي وأستاذي منير العكش: "حين وصل كولومبوس إلى أميركا، كان عدد سكان الجزيرة البريطانية 4 ملايين فقط. وفي العام 1900، كان عددهم 41 مليوناً (أي أكثر من 10 أضعاف ما كان عليه أيام كولومبوس). هذا يعني أنَّ عدد السكان الأصليين في المنطقة التي تسمى اليوم الولايات المتحدة، "لو تزايدوا بالنسبة نفسها، كان يجب أن يكون عددهم في العام 1900 في حدود 185 مليون إنسان".
طبعاً، كان للأوبئة التي حملها الأوروبيون دور كبير في تفسير هذه الأرقام المرعبة، ولاحقاً في قيام الإمبراطورية الأميركية التي هيمنت على العالم. هذا العالم، مثل العالم الذي سبقه، دخل مرحلة الأفول الآن...